صدور "أنتَ شريكٌ في تكوينِ المعنى" لمنير فاشة
نشر بتاريخ: 2018-05-29 الساعة: 09:37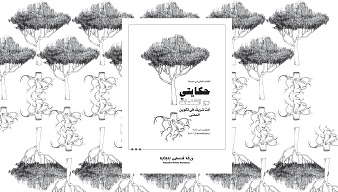
رام الله - الايام- أصدرت ورشة فلسطين للكتابة، بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي الحادي عشر، الكتاب الثاني من سلسلة "حكايتي مع الكلمات" تحت عنوان أنتَ شريكٌ في تكوينِ المعنى ، للمفكر منير فاشه. هذا الكتاب هو الثاني بعد الكتاب الأول من السلسلة، الذي أصدرته الورشة قبل سنتين. وضع رسومات الكتاب وصممه الفنانة يارا بامية التي أخرجت الكلمات من الخطوط إلى الشكل ومن الصوت إلى الفراغ. يتابع منير فاشه في هذا الكتاب كما في كتابه الأول البحث في الكلمات وتفكيكها لما لها من دور في تشكيل من نحن وكيف يرانا العالم وكيف نراه. الكتاب الموجه أساساً لليافعين واليافعات يقارن بين نوعين من الكلمات، الكلمات المغدية مقابل الكلمات التي نستهلكها ونرددها دون تفكير. ونورد هنا ما جاء في مقدمة الكتاب على لسان منير فاشه:
هذا الكتابُ هو الثاني من سِلسلةِ "حكايتي مع الكلمات". وينطلِقُ -كما الكتابُ الأول- من الاقتناعِ بأهميةِ دورِ الكلماتِ في حياتِنا كأشخاصٍ ومجتمعات، ودخولِها في تكوينِ فِكرِنا وإدراكِنا وأفعالِنا وعلاقاتِنا. وجوهرُ هذه السلسلةِ هو الاقتناعُ بأن كلَّ إنسانٍ شريكٌ في تكوينِ المعنى. في هذه السلسلةِ، لا أسعى إلى حكايةِ قصصي مع الكلماتِ فقط، بل إلى حثِّ القُرّاءِ، خاصةً اليافعين واليافعاتِ، للتفكيرِ بكلماتٍ آذَتْهُم، وكلماتٍ غَذَّتْهُم، وروايةِ قصصِهم معها هم أيضاً، وحثِّهم لممارسةِ حقِّهم ومسؤوليتِهم وقدرتِهم البيولوجيةِ في توليفِ معانٍ لكلماتٍ لها أثرٌ كبيرٌ في حياتِهم. الشراكةُ في تكوينِ المعنى تُجسّدُ كرامةً واحتراماً وحريةً ومساواةً وتعدديةً، ما يسهمُ في حمايتِنا من أمراضٍ وأوهامٍ وخرافاتٍ حديثةٍ. هذه الشراكةُ قدرةٌ بيولوجيةٌ لا تحتاجُ إلى تدريسٍ، وهي واجبٌ على كلِّ شخصٍ، وحقٌّ أصيلٌ لكلِّ إنسانٍ، مغيّبٌ من الإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الإنسانِ واتفاقيةِ حقوقِ الطفل!.
"الشراكةُ في تكوينِ معنى" تجسّدُ أعمقَ معنىً للديمقراطيةِ، ديمقراطيةِ المعنى، التي تختلفُ جذريّاً عن ديمقراطيةِ التصويتِ. ديمقراطيةُ المعنى لا تحتاجُ إلى مؤسساتٍ وإذْنٍ. علينا أن نسعى لممارستِها في التعليمِ المدرسيِّ والجامعيِّ، كما في الحياةِ عامةً.
يركزُ الكتابُ الثاني هذا، على التمييزِ بين نوعين من الكلماتِ: كلماتٍ مؤسسيةٍ وكلماتٍ حيّةٍ، كلماتٍ أغلبُها مُؤذٍ وكلماتٍ مُغَذِّيةٍ. تَصْدُرُ الكلماتُ المصنعةُ عن مؤسساتٍ رسميةٍ وسلطةٍ تتحكمُ بمعاني الكلماتِ عبر مِهْنِيّين يَفْعلونُ ما يُمْلى عليهم. وهَدَفُ اللغةِ الرسميةِ، وَفْقَ مصممها، هو قَوْلَبَةُ العقولِ.
أما الكلماتُ الحيّةُ، فيجتهدُ الناسُ -عبرَ أفعالِهم وتفاعلاتِهم وتأملاتِهم- في تكوينِ معانٍ لها وطرقِ استخدامٍ. تَرْسُمُ اللغةُ الحيّةُ صُوَراً في الذهنِ، ولها دلالاتٌ في الحياةِ، وتتكوّنُ معانيها ضمنَ سياقاتٍ، وتُرافِقُ الأفعالَ، وتُصْقَلُ باستمرارٍ كنتيجةٍ للتأمّلٍ فيما يمرُّ به الشخصُ، وتتمثلُ بالتحادثِ والقصصِ والأدبِ والشعرِ.
في المقابلِ، الكلماتُ المصنَّعَةُ لا تكوّنُ صوراً في الذهنِ، ولها إيحاءاتٌ أكثرُ من دِلالاتٍ. وشكّلت الاستعاضةُ عن لغةٍ حيةٍ بلغةٍ مصنَعَةٍ، بِدْءاً في أوروبا، الخللَ الأعمقَ في الحياةِ المعاصرةِ.
نحنُ نستهلكُ معانيَ ومعارفَ جاهزةً، تُحوّلُنا -نحن والمعرفةَ- إلى سِلَعٍ في سوقِ الاستهْلاكِ.
ثَمَّةَ قَوْلٌ لجلالِ الدينِ الروميِّ قبلَ 800 سنةٍ، أَجِدُهُ مُناسِباً ومُلهِماً جِدّاً في يومِنا هذا: "ربما تبحثُ بينَ الأغصانِ عمّا يظهرُ فقط في الجذورِ".
التعرُّفُ على معاني كلماتٍ من معجمٍ أو قاموسٍ أو خبيرٍ أمرٌ ينتمي إلى الأغصانِ، والشراكةُ في تكوينِ المعنى تنتمي إلى الجذورِ. ديمقراطيةُ التصويتِ تنتمي إلى الأغصانِ، وديمقراطيةُ المعنى تنتمي إلى الجذورِ. التقييمُ العموديُّ ينتمي إلى الأغصانِ، و"قيمةُ كلِّ امرئٍ ما يُحْسِنُه" تنتمي إلى الجذورِ. صِحَّةٌ تنتمي إلى الأغصانِ، وعافيةٌ تنتمي إلى الجذورِ. لغةُ الكتبِ المقررةِ تنتمي إلى الأغصانِ، واللغةُ التي هي بمثابةِ بيانٍ يبيّنُ ما في داخلِ الشخصِ تنتمي إلى الجذورِ.
مسؤوليةُ كلِّ شخصٍ أن يقررَ بنفسِه فيما إذا كان ما يقولُه أو يفكرُ فيه أو يفعلُه ينتمي إلى الأغصانِ أم إلى الجذورِ. الغرضُ من هذه السلسلةِ هو البحثُ والتفكُّرُ والعملُ على صعيدِ الجذورِ. يعرضُ هذا الكتابُ أمثلةً، وكلُّ مثالٍ يحتوي على كلمتين: إحداهما يَصْدُرُ معناها من مؤسساتٍ ومِهْنِيّين، بينما الثانيةُ ينبُعُ معناها من الحياةِ والتأمُّلِ والاجتهادِ. وقوْلُ الروميِّ سيساعدُنا في التمييزِ بينَ النوعين.
لقد شجّعَتْني على كتابةِ هذا الكتابِ الثاني الطفلةُ أفنان من مخيمِ جباليا في قطاعِ غزةَ، التي التقيتُ بها عبرَ "سكايب" بدعوةٍ من بيتِ الأدبِ بمركزِ الطفلِ/ مؤسسةِ القطان بغزة. قالت أفنان: "عندما كنتُ صغيرةً، كنتُ أراقبُ الفتياتِ الجميلاتِ وأقولُ لنفسي: لم لا أكونُ مثلَهُنّ جميلةً؟ كنَّ كلما آتي إلى المدرسةِ، يَهْزَأْنَ منّي لأنهنَّ أجملُ منّي. وفي يومٍ من الأيامِ، سأَلَتِ المعلمةُ سؤالاً، فلم يرفعْ أحدٌ يدَه إلا أنا. وكان سؤالُها: ماذا يعني الجمالُ؟ فقلتُ لها: الجمالُ في الكتابةِ والعقلِ، وليس في الحُلِيِّ. صَفَّقَ لي جميعُ الصّفِّ، رُغْمَ أَنّني لم أكنْ واثقةً من كلامي. وقتَها، أدركتُ أن الجمالَ ليسَ حلاوةَ الوجهِ، وإنما في العقلِ والفَهْمِ". قولُها جعلَ عينيَّ تدمعان.
أُرْسِلَ الكتابُ الأولُ إلى مؤسساتٍ ومجموعاتٍ كثيرةٍ تعملُ مع الأطفالِ واليافعين في فلسطينَ، ولديهم اهتمامٌ بكتبٍ لهذه الفئةِ العمريةِ. لم تهتمَّ أيُّ مؤسسةٍ بالكتابِ، سوى مركَزِ الطفلِ! وأعتبرُ شَخْصيّاً أن الكتابَ من أهمِّ ما كتبتُ، من حيثُ تركيزُه، بدءاً بالأطفالِ واليافعين، على مصدرِ شفائِنا من أخطرِ "فيروس" فكريٍّ، احتلالِ كلماتٍ ومعانٍ رسميةٍ محلَّ كلماتٍ ومعانٍ حيّةٍ. كانَ حديثُ الأطفالِ عبرَ "سكايب" أقربَ ما سمعتُه لروحِ الكتابِ. سألتُ في نهايةِ اللقاءِ عن الفرقِ بين التعلُّمِ والتعليمِ. قامَ طفلٌ وقالَ: "التعلُّمُ شيءٌ أفعلُه لنفسي، والتعليمُ شيءٌ يفعلُه آخرونَ لي". يا إلهي! لخّصَ ذلك الطفلُ في بضعِ كلماتٍ ما لم أقرأْه أو أسمعْه من تربويّينَ عالميّينَ يعتقدونَ أن التعليمَ الرسميَّ يؤدي إلى تعلّمٍ وفَهْمٍ!
ما سمعتُه من أطفالِ غزةَ أثلجَ صدري وشحنَني بمشاعرَ مليئةٍ بالأملِ غائبةٍ من "المستوطناتِ المعرفيةِ"، المدارسِ والجامعاتِ التي نعيدُ فيها كالببّغاءِ ما نقرأُه في كتبٍ مقررةٍ، وما نسمعُه من "خبراءَ"، همُّهُم الرئيسيُّ إقناعُ الناسِ بأنَّ الماضي متخلفٌ وولّى زمانُه. قلتُ في نهايةِ اللقاءِ كيف كنّا نذهبُ في عَقْدِ السبعينيّاتِ من رام الله إلى غزةَ لنستقيَ منها ومن أهلِها روحاً نفتقدُها عندَنا، وإني سعيدٌ لأنّ اللقاءَ أكدَّ لي أن تلكَ الروحَ لا تزالُ حيّةً بغزةَ.
***
يمكنُ تلخيصُ حياتي كفلسطينيٍّ، منذُ ولدْتُ عامَ 1941 باحتلالٍ وعودةٍ، بدءاً بالاحتلالِ الإنجليزيِّ، وانتهاءً باحتلالِ البنكِ الدوليِّ. نعيشُ احتلالاتٍ على أصعدةٍ شتّى. نَعي احتلالَ الأرضِ، لكنّنا لا نعي احتلالَ العقولِ عبرَ كلماتٍ ومعانٍ مصنَّعةٍ محلَّ كلماتٍ ومعانٍ نابعةٍ من الحياةِ. الأداةُ الرئيسيةُ في كلِّ الاحتلالاتِ كانت المستوطناتِ، بدءاً بمستوطناتٍ معرفيّةٍ كانت أولاها ببلادِ الشامِ "الجامعةَ الأمريكيةَ في بيروتَ" عامَ 1869، تبعتْها بعدَ 70 سنةً مستوطناتٌ عسكريةٌ، ثمّ بعدَ 30 سنةً مستوطناتٌ سكنيةٌ، وبعدَ 30 سنةً أخرى، شملت مستوطناتٍ على شتّى الأصعدةِ، مثلَ شركاتِ أطعمةٍ مزيفةٍ وترفيهٍ إلكترونيٍّ وبنوكٍ "وطنيةٍ".
أما بالنسبةِ للعودةِ، فكانت أولُ عودةٍ لي، ليس إلى بيتِنا في "البقعةِ التحتا" بالقدسِ الغربيةِ الذي هُجِّرْنا منه عامَ 1948، بل عودةٌ إلى عالَمِ أُمّي الأُمّيةِ الغنيِّ وذاتِ الجذورِ في الحياةِ، وإلى المعرفةِ النابعةِ من الانتباهِ الشديدِ للواقعِ الذي نعيشُه، وإلى الحضارةِ العربيةِ كأساسٍ ومرجِعٍ للفكرِ والإدراكِ والبيانِ وجَدْلِ أنسجةٍ على أصعدةٍ شتّى. وَعَيْتُ أنّ ما غَيَّبَتْهُ المستوطناتُ المعرفيةُ هو أهمُّ ما ميّزَ الحضارةَ العربيةَ في ذُرْوتِها: الحكمةُ. العقلُ، دونَ حِكمةٍ كرفيقةٍ له، يسيرُ بسرعةٍ، لكنْ يخلّفُ وراءَه خراباً كثيراً كما نشهدُ حاليّاً.
عودتي على الصعيدِ المعرفيِّ بدأت بمحاولةِ استعادةِ الحكمةِ كبوْصلةٍ أستهدي بها بحياتي: من سعيٍ لتغييرِ المجتمعِ إلى عَوْدٍ لتغييرِ ذاتي، من اعتبارِ الحوارِ وسيلةً للتفاعلِ إلى عودةٍ إلى الجوارِ، من كتبٍ مقرَّرةٍ إلى كتبٍ هي بمثابةِ بيانٍ وتبيينٍ، من جَدَلٍ إلى جَدْلٍ، من الصحةِ إلى العافيةِ، من كوني مواطناً إلى كوني أنتمي إلى أَهالٍ، من العيشِ بوهمٍ إلى العيشِ بفهمٍ، من اعتبارِ النظرياتِ منطلقاً إلى اعتبارِ الاندماجِ بالحياةِ والتأملِ فيها والاجتهادِ في تكوينِ معنىً لها كمنطلقٍ، من كلماتٍ مؤسسيةٍ وتصنيفاتٍ أكاديميةٍ إلى حياكةِ قصصٍ وَجَدْلِ نسيجٍ فكريٍّ اجتماعيٍّ ثقافيٍّ مع عربٍ وأكرادٍ وأمازيغَ وسريانٍ، ومن لهم جذورٌ بالمنطقةِ، ومع جيرانٍ تاريخيين. عودتي لفلسطينَ كنسيجٍ اجتماعيٍّ ثقافيٍّ، ما كان له معنىً دونَ العودةِ إلى الحضارةِ العربيةِ.
تجدون كتاب "حكايتي مع الكلمات" وكافة كتب ورشة فلسطين للكتابة في مكتبة الشروق في رام الله، ولدى منشورات المتوسط في معارض الكتاب العربية أو بالتواصل المباشر مع الورشة.